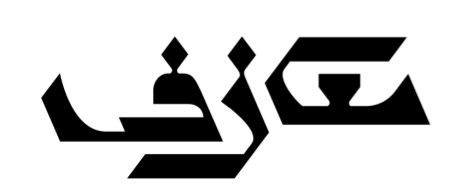إذا رغب المستعمِر بالعودة إلى وطنه، أو إذا كان هناك مكان يتوق للذهاب إليه لكنه على الأغلب لن يصله، قد يقوم ببساطة بتسمية المكان حيث يقيم تيمُّنًا بذلك الذي لا يستطيع وصوله. هذه طريقة لخداع النفس، أو مواساتها، لتصدّق أنها في المكان الصحيح، سواءٌ كان ذلك المكان هو حيث الأصل والجذور، أو حيث الانتماء، كالوطن، أو أي مكان ذي أهمية دينية؛ مكانٌ لا يتخيل أحد أنه سيستطيع دخوله في حياته الدنيا.
انتقلت أسماء العديد من المواقع الإنجيلية إلى أراضٍ في شمال أمريكا، كعلامة مستمدّة من اللغات القديمة تغرز فكرة أن هذه المنطقة أرضُ ميعاد، ميعاد امتدّ ليشمل قيام المستعمرين الأوروبيين بدور إلهٍ مسيحيّ. إلا أنه في الأغاني الشعبيّة في جنوب الولايات المتحدة، ربما لا يرد ذكر أي موقع إنجيلي بقدر ما يرد ذكر نهر الأردن.
خلال حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية، كان نهر أوهايو خطًا فاصلًا بين الكونفدرالية، حيث العبودية لم تكن فقط شرعيّة، بل ومدعّمة بسلسلة من أفعال العنف الأكثر من شرعيّة، وبين الشمال، حيث أصبحت العبوديّة مخالفة للقانون وأصبح يقال إن الحرية حق، ما جعل الأرض شمال خط ماسون-ديكسون نوعًا آخر من أرض الميعاد. بين أروقة السكك الحديدية التحت أرضية، تلك الشبكة السريّة من مناهضي العبوديّة الذين عملوا تحت غطاء الليل لتحرير المستعبدين، كان يشار إلى نهر أوهايو بـ نهر الأردن، وإلى عرّابته هارييت توبمان بـ موسى، الذي يقدّم المعبر الآمن عبر المياه الغادرة.
لم تكن العلاقة السرية بين نهر أوهايو ونهر الأردن مقصورةً على الشيفرات الداخلية للسكك تحت الأرضية، بل كانت تُشفَّر الكثير من الأغاني التي ينشدها المستعبدون بنفس الطريقة، بحيث يستطيع الساعون إلى الانعتاق من مزارع الرق التخطيط لهروبهم تحت غطاء الطقوس التعبديّة الخاصة. عندما يتجمّع حشدٌ من المستعبدين في برّيّةً على حافّة مزرعة الرق، مغنين: “أنا ذاهبٌ إلى نهر الأردن / أنا ذاهب إلى نهر الأردن في غدٍ ما / هاللويا …” كان المعنى المفهوم من قِبَل المجتمعين “في سبيل الله” أن الحرية قريبة؛ وعندما تجتمع هذه الأبيات مع أخرى مصاحبة لها عادةً، مثل: “سأخبر الرب كيف تعاملني” و”سآكل على طاولة الترحاب”، بين أبياتٍ أخرى، لا يبقى الكثير من الغموض حول من وما تشير إليه السطور.
بالنظر إلى العنف الذي لا يمكن تصوره والمسلّط على المزرعة في سبيل الحفاظ على نظام العبودية، والخطر الكبير المتأصّل في محاولة الهرب، قد يعتق الموت المستعبدين قبل حتى أن يستطيعوا ملاقاة أحد دعاة إلغاء العبودية في ظلام الليل الكالح، هامسين في ظل هدير نهر أوهايو، بمجدافٍ بين أيديهم وجاهزيّةٍ للفرار. لذا عندما غنى المستعبدون للحرية، كان ذلك بناءً على إدراك أنه ربما يعرف البعض معنى الحرية في الشمال، بينما قد لا يلتقي البعض الآخر مع الحرية إلا في الحياة الآخرة.
يظهر نهر الأردن في العديد من الأغاني كمكانٍ للعبور، لكن ليس كما يعبر البحّار أو المراكبي، وإنما كما يكون العبور في الموت أو في رحلةٍ روحانيةٍ أخرى. عندما يُغنّى في النشيد الإنجيلي الشهير: “عليّ أن أعبر نهر الأردن / عليّ أن أفعلها بنفسي”، والذي قد يبدأ بـ “عليّ أن أحتمل اختباري وعقابي” أو بـ “عليّ أن أمشي في ذلك الوادي الموحِش”، من الواضح أن عبور نهر الأردن اختبارٌ روحاني لا يُمكن تفاديه ويجب أن تخوضه وحدك.
بالنسبة للمنحدرين من أولئك الذين اختبروا أهوال الممر الأوسط (طريق الأفارقة المستعبدين من موطنهم إلى العالم الجديد عبر المحيط الأطلنطي)، ومن سعوا إلى الحرية بعبور نهرٍ إلى الشمال، ربما لم يصادفوا مجازًا كهذا، معبّر بقدر ما هو مشهود، على أن عبور الماء يترك أثرًا باقيًا. كانت هذه الرحلة الطويلة عبر البحر تروماتية بالنسبة للكثير من الأوروبيين، ويجب أن لا تتكرر في أي حال من الأحوال، معتبرين “العالم القديم” مُجرّد عالمٍ قديم، “شاطئٍ سماوي” لا يوجد إلا في الذاكرة، أو في فضاء ميتافيزيقي ما، ولا يمكن الحديث عنه خارج هذا الإطار.
في الجنوب، في حين قدمت بعض الكنائس خدمات للمجموعات المختلطة الأعراق، خلال فترات الفصل العنصري المفروض من قبل الدولة، جرى فصل العرقين بشكل صارم. حتى إن أنشدت كنائس البيض والسود التراتيل المعمدانية ذاتها، وكانوا يسمعون غناء بعضهم في معظم الأحيان منبعثًا من دور العبادة، أو لاحقًا، على الأمواج القصيرة لبث الراديوهات المحلية، بحيث تطوّرت الأنغام ذاتها بشكل منفصل، لكن في اتجاهات أسلوبية متوازية. لهذا، دخلت هذه التراتيل أراشيف فرق الوتريات، والتي تراجعت شعبيّتها بين الأفارقة الأمريكيين بحلول نهاية القرن العشرين، كما دخلت إلى أداءات عازفي البلوز، الأكثر دنيوية.
بالإضافة إلى كونه فاصلًا حدوديًا بين الجنوب المتمسّك بالعبودية وبين أرض تعِد بالحرية، أو إلى كونه نهرًا على شاطئه البعيد حياةٌ أبديّة، كان نهر الأردن المكان الذي عمّد فيه يوحنا المعمدان المسيح، وهو حيث تنبّأ كلٌّ من يوحنا المعمدان وأشعياء بقدوم المسيح، وحيث كان المؤمنون يعبرون لسماعه يتكلم وليشفيهم. لذا أصبح نهر الأردن وماؤه رديفًا شاملًا لتجربة التعميد، ومكانًا روحانيًا حيث ولدت الرؤى النبويّة، والشفاء والبداية الجديدة، بعيدًا عن التعاملات اليومية للحياة الدنيا:
“حسنًا، أنا ذاهبٌ إلى نهر الأردن / سأدفن ركبتاي في الرمال / سأنشد المدائح / وسأبلغ الأرض الموعودة / حسنًا إني نظرت إلى هناك / فماذا تظن أني رأيت؟ / أرى فرقةً من الملائكة / إنهم قادمون لأجلي.”
في العديد من الخطب التي تُسمع في كنائس السود، وفي ما أطلق عليه أحيانًا لاهوت تحرير السود، هنالك عادةً ارتباطٌ قوي بأسر اليهود من قبل فرعون مصر، حيث كان عبور نهر الأردن فعلٌ إيمانيٌّ أخير بعد إطلاق السراح والعودة إلى الوطن. في أغنية الغريب المسافر، أو الحاج السائر، عندما تُغنى جملة: “أنا فقط ذاهب إلى نهر الأردن، أنا فقط عائدٌ إلى وطني”، العلاقة بالماء ليست في سجل المرجعيات الإنجيلية لقصة الأسر في مصر والعودة إلى إسرائيل، وإنما هي مرتبطة بالعودة إلى موطن قائم قبل هذه الحياة، وهو ما سيدوم بعد أن يفنى الوطن الذي نعرفه على الأرض، وهو المكان حيث سننضم إلى أولئك الذين رحلوا منذ زمن. عندما تُغنى جملة: أنا ذاهبٌ إلى هناك لأقابل أمي / ذاهبٌ إلى حيث لا أهيم بعد ذلك”، يمكن قراءة هذه الرحلة كتجربة روحانية، ورحلة أخيرة ستنهي متاعب الواصل، تاركًا وراءه كل فوضى الأماكن والأسماء المختلفة والأغاني الشاهدة على المِحًن والنِعَم.
ربما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بقرب نهر الأردن، يبدو النهر هائل التاريخ والقصص، لكنه واقع، بثروته المائية التي تعاني من سفن الشحن والتلوّث، ومعابره المكتومة الأنفاس بالاحتلال. لكن بينما تتدفق بعض الأنهار عبر صفحات الكتب المقدّسة، مرسلةً أتباعها إلى المعابد ومنها، تتسع روافدها لتلمس قبّة السماء، وتُسمع مياهها المتدفّقة في الصلوات والأغاني، حاملةً العُبّاد المنقولين عبرها في عزلةً مطلقة، أو المجتمعين في نوبة استغراق دينية:
“نهر الأردن يبعد أميالًا عدّة / وهذا النهر العظيم قد لا أراه أبدًا / لكنني قد أجد نفسي مذبحًا في كنيسةٍ قديمة / ويكون هذا نهر أردني.”